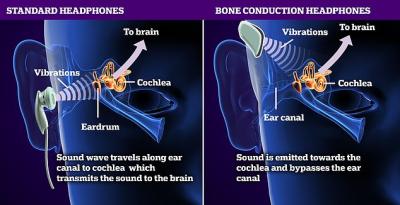بقلم/ د. منار الشوربجي
هل هناك علاقة بين التعليم والتكنولوجيا وصحة أبنائنا؟ وهل بالإمكان أن يصبح التعليم تجربة مفيدة وممتعة معاً؟ وهل تقيس التكنولوجيا المستوى الصحي للأبناء؟.
أم أن صحتهم هي التي تحدد طبيعة التكنولوجيا الواجب استخدامها؟ كل تلك الأسئلة وغيرها تشغل الذين يعملون بالتدريس بالجامعات والمدارس بمراحلها المختلفة لكنها باتت، مع جائحة كورونا، تهم كل أطراف العملية التعليمية، أي المدرس والطالب وولي الأمر والمؤسسات التعليمية.
فقد وجدنا أنفسنا، فجأة، إزاء واقع مغاير لم نعشه من قبل. فمع الإجراءات الاحترازية وضرورة التباعد الاجتماعي، تم اللجوء إلى التعليم عن بعد، فاختلفت خبرات الطلاب. فبعضهم صار يتلقى دروسه عبر تسجيلات صوتية، بينما تلقاها آخرون عبر التفاعل المباشر عن بعد مع المدرس.
وقد فرض ذلك الواقع الجديد تحديات من نوع جديد. وهي تحديات لم تقتصر فقط على الإمكانات المادية، وإنما تعلقت أيضاً بالمهارات والملكات الشخصية التي لم يكن أحد يتصور أن تكون يوماً جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية.
فعلى سبيل المثال، فرض التعليم عن بعد على كل أسرة أن تهيئ بالمنزل الواحد أكثر من مكان هادئ ومنفصل لكل من أبنائها ليتلقى دروسه دون تشويش يزعجه أو يزعج باقي أفراد الأسرة.
والطالب وجد نفسه إزاء ساعات طويلة يقضيها أمام الشاشة بين درس وآخر يحاول فيها التكيف مع الأساليب التي اختلفت من مدرس لآخر كان هو نفسه لا يزال يتدرب على التدريس عن بعد.
وعلى عكس ما يتصور البعض ولسبب لا زلت لا أفهمه بالضبط، فإن التدريس عن بعد يصيب المدرس بدرجة أعلى بكثير من الإجهاد الذهني، بالمقارنة بالتدريس وجهاً لوجه. ولعل السبب هو أن التدريس، الشاق أصلاً، يضاف له جهد التركيز المستمر على الشاشة. ومن هنا، كنت أشعر بمدى معاناة طلابي.
فإذا كان هذا هو حالي مع التدريس عن بعد، فما بالك بشباب صغار في أوج النشاط بات عليهم ليس فقط البقاء في بيوتهم وإنما أن يتسمروا أمام الشاشة لساعات طويلة للتحصيل والدرس. ولم أندهش في الحقيقة عندما أثبتت الدراسات تعرض نسبة مرتفعة منهم للاكتئاب زمن جائحة كورونا.
غير أن الأخطر من هذا وذاك كان مسألة الاختبارات. فقد لجأت الكثير من المؤسسات التعليمية لتوفير برامج إلكترونية للأساتذة تستخدم لمراقبة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات. ولا أخفي عن القارئ أنني رفضت تماماً استخدام تلك الوسائط ولجأت، بدلاً منها، لأسلوب اختبارات الكتاب المفتوح.
وكان رفضي نابعاً من سببين أولهما أن تلك البرامج كانت تمثل انتهاكاً صارخاً لخصوصية طلابي. فهي تسمح للأستاذ بأن يطالع كل ما هو متاح للطالب على جهازه الإلكتروني، بل ويمكنه رؤية البيئة المحيطة به أي غرفته. أما السبب الثاني، فكان أن تلك البرامج لم تكن، في تقديري، وسيلة عادلة لتقييم الطلاب.
فأغلبها كان يهدف لمنع الغش ولكن بأساليب لم تأخذ في اعتبارها التباين بين طالب وآخر في القدرة على التركيز على الشاشة التي أمامه. وقد وقعت عيني أخيراً على دراسة أثبتت صحة تقديري هذا.
فقد اكتشفت تلك الدراسة أن مثل هذه البرامج تلتقط زوراً الطالب الذي يعاني من مرض اضطراب نقص الانتباه أو من فرط الحركة وتعتبره يغش لأنه يشيح بوجهه بعيداً عن الشاشة أو يحرك أطرافه بشكل لا يفهمه طبعاً البرنامج. وعقاب طالب دون ذنب هو أخطر ما يمكن لمؤسسة تعليمية أن تفعله.
باختصار، لقد فرضت جائحة كورونا تحديات كبرى على كل أطراف العملية التعليمية ولكنها كانت تجربة مفيدة تعلم منها الجميع. ولعل أهم ما تعلمناه هو أن تكنولوجيا المعلومات رغم فوائدها الهائلة في العملية التعليمية إلا أنها، مثلها مثل كل الوسائط، تحتاج للفحص والتدقيق لمعرفة ليس فقط فاعليتها وإنما تأثيرها على صحة أبنائنا وثقتهم في أنفسهم.
ولا شك عندي، بعد تلك التجربة، من أن التفاعل وجهاً لوجه لا غنى عنه في العملية التعليمية. فالتعليم ليس مجرد نقل للمعرفة من عقل لآخر أو من كتاب ما لعقل بشري وإنما هو تبادل للأفكار والقيم والمعاني.
manarmes@yahoo.com
نقلاً عن البيان