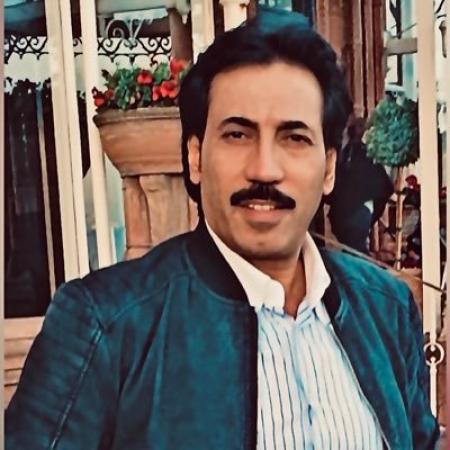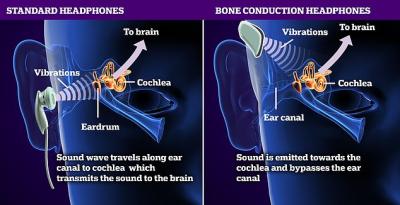بقلم/ أحمد الحباسى
السياسة أو بمعنى أصحّ الكتابة في السياسة هو انتحار ، لست في حاجة للانتحار على الأقل هذا ما تردده و تعيده زوجتي كل لحظة تمرّ فيها أمام جهاز الكمبيوتر و حتى تقنعني أكثر فهي لا تتردد أن تسألني يا رجل هل أنت في هذا السن قادر على مواجهة متاعب الزنازين ؟ . في العادة اكتفى بابتسامة بلا معنى و أحيانا أحاول إقناعها بأن الصمت جريمة و أن عدم مواجهة الطغيان سيجعله يتمدد بقوة بحيث يتم القضاء على المكسب الوحيد و اليتيم الذي حققته " الثورة " و هي حرية التعبير . بطبيعة الحال مثل هذا الرأي لا يقنع زوجتي و لذلك بقينا على خلاف لا ينتهي إلا برحيلي عن هذه الحياة الفانية أو بتعرضي للسجن و هما أمران لا يروقان لها و تصر على أن الحل موجود و لكن تنفيذه يحتاج فيما يحتاج أن أتخلى عن شيء من عنادي و نرفزتى و رغبتي المستمرة في مواجهة واقع لم يعد يحتمل بل بات مصدر إزعاج لكل إنسان حرّ.
في الحقيقة أنا مللت السياسة و كرهت أغلب السياسيين و طالما فكرت في الانسحاب من الحلبة لاعنا اليوم الذي ظهر لي أن أحمل القلم و أمارس هواية الكتابة السياسية و لا أذيع سرّا أنى فكرت في الاعتزال بمحض إرادتي و بدون أن أتعرض إلى المساءلة أو الإيقاف و لعله من واجبي اليوم أن أتوجه بكامل عبارات التقدير لكل رؤساء تحرير المواقع الالكترونية التي تشرفت بالمساهمة فيها و الذين تحملوا كثيرا من العناء لإقناعي دائما بتخفيض منسوب الانتقاد تجنبا للمساءلة و رفعا للحرج عن هذه المواقع التي باتت هي الأخرى عرضة للتتبعات و السين و الجيم و التلميح و التصريح . أيضا لا أذيع سرّا حين أكشف أن ما حدث منذ 14 جانفى 2011 من اغتيالات و خيانة و نهب لأموال الدولة و بيع مؤسساتها لدول أجنبية متآمرة و ضرب حرية التعبير و خنق الحريات و انتشار لفكر الإخوان الفاسدين هو من فرض فرضا على و على أمثالي فكرة الكتابة على الأقل لرفع الصوت و مواجهة الطوفان. فعلا أنا مدين لحركة النهضة و للشيخ راشد الغنوشى و من تآلف معهم من غلمان السياسة و تجار الكلام المزيف بانتباهي إلى كوني أملك بعض أدوات الكتابة السياسية و لا أنكر سعادتي بامتلاك سلاح الكلمة في مواجهة فكر التطرف و الإرهاب .
في الحقيقة الكتابة متعة كبرى و المقال الجيّد لا يأتي هكذا بل يلزمه كثير من الاطلاع و التثبت و الدقة بل أن الصعوبة تكمن في رأى رئيس التحرير المطالب كما أعلم بأن يمسك العصا من النصف و في بعض الأحيان فهو لا يرى بأسا من رفض المقال جملة و تفصيلا و دون أبسط اعتذار أو تفسير كل ذلك ليتجنب ما تحمله بعض المكالمات الهاتفية من غلظة و تحذير و يجنبني قسوة تطبيق المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي يعتبره الجميع سيفا مسلطا على ما يخرج من القلم من نقد لاذع و عبارات يعتبرها قاضى التحقيق مسّا من الذات الرئاسية أو خروجا عن آداب الخطاب السياسي . لعل المطلوب من حكامنا و من يحتجزون السلطة المطلقة و من يتباهون علنا و دون حمرة خجل بأنهم ديمقراطيون أن يتفهموا على الأقل و من أضعف الإيمان بأن تلك السلطة المطلقة قد تسببت فيما تسببت إلى بروز كتاب البلاط المنافقين المضللين للرأي العام و تضائل أعداد الكتاب الشرفاء بعد أن تعرضوا للتنكيل المبرح المتواصل و قطع الأرزاق و مواجهة محاكمات الرأي. عليهم أن يتفهموا أن الكتابة تحت القمع هي كتابة مختلفة عن الكتابة في مناخ سليم و لذلك تخرج العبارات جارحة مستفزة و غير موضوعية أحيانا من باب ردّ الفعل .
يقال و الله أعلم أن الكتابة صوت من لا صوت له و أنها تخلد الفكرة حتى لا يطويها زمن النسيان لذلك ربما لا يعرفك أحد حين تكتب لكن كتاباتك تبقى ملتصقة بذاكرة كل من يقرأها خاصة إذا كانت المقالات تمس وجدانه و تعبّر عن خلجات أفكاره . الكتابة زواج متعة بين القلم و الفكر لكن كم هي متعبة و صعبة و مؤذية في زمن الاستبداد و الديكتاتورية و ضرب حرية التعبير لذلك يلاقى مثلى نصائح ذوى القربى حتى أركن إلى التقاعد المبكر تجنبا لطرق الباب في النزع الأخير من الليل و فتحه لاستقبال من بات الجميع يعرفهم بزوار الفجر في فيلم " نحنا بتاع الأوتوبيس " للروائي المصري الشهير جلال الدين الحمامصى بطولة عبد المنعم مدبولى و عادل إمام . ربما يظن القارئ أن كاتب المقال شخص على درجة من الشجاعة تجعله لا يهاب السجن لكن الحقيقة مخالفة تماما لان الأمر لا يتعلق بما يمكن أن يتعرض له بل بما ستعانيه عائلته في غيابه و هنا يأتي السؤال الدائم : لماذا لا تتوقف عن الكتابة و تريح و تستريح ؟ في قناعتي أنه لا أحد من كتّاب المقال السياسي له جواب أو حل لكن ما أنا مقتنع به أشد الاقتناع أنى أرفض أن أكون ضيفا سلبيا على الدنيا و لا توجد راية بيضاء في مكتبتي .
*كاتب و ناشط سياسي