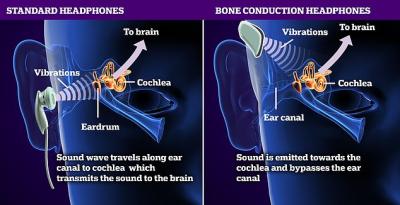بقلم/ مصطفى غَلمان
يشهد الفضاء الرقمي، ولا سيما منصات التواصل الاجتماعي، تمدّداً لظواهر سلوكية شاذة لا تقف عند حدود التعبير الفردي، بل تنفذ عميقاً إلى البنية الرمزية للثقافة، مهدِّدةً صدقيتها التاريخية وأسسها الأخلاقية التي تشكّلت عبر التراكم الاجتماعي والمعرفي. ففي هذا المجال الافتراضي، يتكاثر حضور من يقدّمون أنفسهم بوصفهم فاعلين ثقافيين، بعد أن أخفقوا في بناء مشروعية واقعية، فيستعيضون عن الاعتراف الاجتماعي بتموضع رقمي قائم على استجداء المتابعة وافتعال الظهور.
وتكشف هذه الممارسات عن نماذج بشرية تحرّكها شهوة الزيف والتناقض، حيث تتجاور المجاملات الاحتفالية مع تنافس فجّ واستعراض متكرر، في انفصال شبه كامل عن الوظيفة التاريخية للثقافة بوصفها وسيطاً بين الفرد والمجتمع، وعن دور المثقف في ترسيخ القيم المشتركة، وصيانة الأعراف، وتنشيط الوعي النقدي.
وفي السياق، يتحوّل الفعل الثقافي من ممارسة تأسيسية إلى أداء عابر، يُقاس بعدد التفاعلات لا بعمق الأثر. وفي مقاربة سوسيولوجية-فلسفية لهذه التحولات، يرى باحثون في سوسيولوجيا التواصل أن السلوكات الرقمية الجديدة لا تنشأ في فراغ، بل تتغذّى من مخيال اجتماعي مأزوم، تنسجه بدهيات مشحونة بالخوف من الإقصاء، وبهاجس التهميش، وبالرعب من فقدان الندية والاعتراف.
هذا المناخ يولّد أشكالاً من السلوك التعويضي، تعكس في جوهرها درجة الإفلاس الرمزي الذي يعانيه المجتمع، لا بوصفه فشلاً فردياً، بل كنتيجة لبنيات هيمنة غير مرئية. وتكمن خطورة هذه التحولات في أن الخوارزميات، بوصفها سلطة جديدة، لم تعد مجرد أدوات تقنية محايدة، بل تحوّلت إلى آليات ضبط وتدجين، تُعيد تشكيل الرغبات، وتكافئ السطحية، وتفرض منطق البقاء عبر التكاذب البنيوي، إذ يصبح التزييف شرطاً للظهور، والاستعراض معياراً للقيمة، بينما يُقصى العمق والتفكير النقدي إلى هوامش غير مرئية. كما يُنصَّب “التريند” كهاجس مركزي، لا يلتهم فقط الزمن والاهتمام، بل يقضي تباعاً على ما تبقى من صورة الثقافة ووظائفها الاجتماعية، محوّلاً المجال العام إلى مسرح للتعالي الفارغ والانتقائية العابرة، حيث تُستبدل الأسئلة الكبرى بإيماءات آنية، ويُختزل المعنى في قابلية التداول لا في قيمته المعرفية أو الأخلاقية.
ومن ثَمّ، لا يمكن النظر إلى انفلات الفضاء الرقمي بوصفه انحرافاً عارضاً أو مجرد فائض تواصلي بلا معنى، بل باعتباره تجلياً بنيوياً لتحولات عميقة تضرب الأنساق الثقافية والفكرية في صميمها. فحين ينشغل هذا الفضاء بالتوافه، وبالأصوات اللقيطة، وبشوارد الأمور، فإنه لا يعكس سطحية المحتوى فحسب، بل يرسّخ نمطاً جديداً من الوعي الزائف، حيث تُقاس القيمة بقابليتها للتسويق، لا بقدرتها على الإضاءة أو التفكيك. وقد نبّه غي ديبور، في حديثه عن “مجتمع الاستعراض”، إلى أن الصورة لا تعود تمثيلاً للواقع، بل بديلاً عنه، وأن ما يُعرض هو ما يُعاش، لا ما يُفكَّر فيه. كما تصبح الأيقونات والرموز المصقولة، والمُجمَّلة بآليات الفوتوشوب، شواهد مقلقة على اتساع الهوّة بين الواقع المعيش والخيال الجامح، بين الحقيقة كما هي، والحقيقة كما يُراد لها أن تُستهلك.
أما حين تتحول القضايا الجوهرية للمجتمع إلى مادة للتسخيف، وتُستبدل الأسئلة الكبرى بمنطق التتفيه، فإننا نكون، بتعبير هربرت ماركيوز، أمام “إنسان أحادي البعد”، يُستنزف وعيه عبر الإشباع السريع، ويُجرَّد من قدرته على الرفض والتفكير النقدي. إذاك لا تُحجب الحقيقة فحسب، بل يُعاد تشكيل الوعي الجماعي على نحو يجعله قابلاً للسقوط والابتذال، ومهيّأً لتقبّل الرداءة بوصفها قدراً يومياً.
ويتقاطع هذا الانزلاق مع تحولات لغة التخاطب داخل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يعد الخطاب الثقافي يُستقبل بوصفه ضرورة مجتمعية أو رافعة للتنمية الإنسانية، بل غدا ـ في نظر كثيرين ـ ضرباً من النفخ في المزامير، أو ترفاً شاذاً لا ينسجم مع منطق السرعة والاستهلاك. وهو ما يذكّر بتحذير ماكس فيبر من “تشييء القيم” داخل مجتمعات العقلانية الأداتية، حيث يُقاس كل شيء بمنفعته المباشرة، وتُقصى المعاني التي لا تُترجم إلى ربح أو انتشار.
وفي ظل هذا التعتيم الرمزي وانعدام الرؤية، يطرح الإعلام الرقمي أسئلة مصيرية حول موقع الثقافة ووظيفتها في عالم تحكمه الخوارزميات. فهل لا تزال الثقافة قادرة على القيام بدورها التأصيلي والتنويري؟ وهل ما زالت تمتلك الطاقة اللازمة لنشر المعرفة وبناء الوعي، أم أنها أُفرغت من مضمونها لتتحول إلى مجرد واجهة زخرفية؟.
يحذّر زيغمونت باومان، في حديثه عن “الحداثة السائلة”، من أن المعنى في زمن السيولة يصبح هشّاً، سريع التبخر، وأن ما لا يُثير الانتباه فوراً يُحكم عليه بالزوال. ومن هنا، فإن الرهان الثقافي اليوم لم يعد محصوراً في إنتاج الخطاب، بل في مقاومة التفاهة، ومساءلة الابتذال، واستعادة الزمن الطويل للفكر في مواجهة الإيقاع المتسارع للاستهلاك الرقمي.
إن ما ينتظر الثقافة، في هذا السياق، ليس مجرد وظيفة إضافية، بل معركة وجودية: إما أن تستعيد دورها كقوة نقدية قادرة على تفكيك الاستعراض وكشف الزيف، أو أن تنخرط بصمت أو بتواطؤ، في إعادة إنتاج الرداءة، وتترك المجال العام نهباً لسطوة “التريند”، حيث يُمحى المعنى، ويُستبدل السؤال بالفرجة، والوعي بالانبهار.
إن الخطر الحقيقي لا يكمن في هيمنة الوسائط الرقمية ذاتها، بل في القبول الصامت بمنطقها حين يتحوّل إلى قدر ثقافي غير قابل للمساءلة. فالفضاء الرقمي، وقد أعيد تشكيله كحقل للعرض لا للفهم، وللصدى لا للمعنى، لا ينتج فقط أنماطاً جديدة من التواصل، بل يعيد هندسة الوعي ذاته، ويصوغ إنساناً مكيّفاً مع السطح، متصالحاً مع الرداءة، وقابلاً للانخراط في الاستعراض بوصفه بديلاً عن الفعل.
إن الثقافة، حين تفقد قدرتها على النقد، وتتنازل عن وظيفتها التأصيلية، لا تموت فجأة، بل تتحلّل ببطء داخل أشكالها الزائفة، وتستمر بوصفها صورة بلا مضمون، أو طقساً بلا روح. وهنا تحديداً تتجلى المفارقة الكبرى. إذ يصبح أخطر ما يهدد الثقافة هو استمرارها الشكلي في غياب جوهرها، واستمرار الحديث عنها في لحظة تآكلها الرمزي.
ومن هذا المنظور، فإن استعادة المعنى لا تمر عبر مجرّد التنديد بالتفاهة، بل عبر مساءلة البُنى التي تنتجها، وتفكيك سلطات الخوارزميات، وإعادة الاعتبار للزمن البطيء للفكر، وللمعرفة بوصفها مقاومة، لا محتوى. فالمعركة اليوم ليست ضد منصات بعينها، بل ضد منطق اختزل الإنسان في قابلية الاستهلاك، والمثقف في قابلية التداول، والثقافة في قابلية الترويج.
وإذ يُستنزف المجال العام بالضجيج، يبقى الرهان الحقيقي معقوداً على قدرة الفعل الثقافي على استعادة موقعه كقوة إضاءة لا كسلعة، وكفضاء للمساءلة لا للتماهي، وكشرط لتحرير الوعي لا لتدجينه. فإما أن يُعاد وصل الثقافة بوظيفتها النقدية والأخلاقية، أو يُترك المجال العام نهباً لاقتصاد الانتباه، حيث لا مكان للسؤال، ولا ذاكرة للمعنى، ولا أفق يتجاوز اللحظة العابرة.
نقلاً عن هسبريس